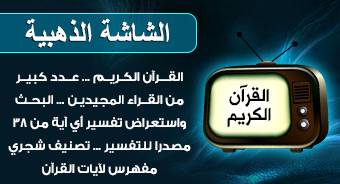|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المشهور بـ «تفسير الألوسي»
{كَيْفَ يَهْدِى الله} إلى الدين الحق {قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إيمانهم} أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسدًا للعرب حين بعث من غيرهم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس مثله، وقال عكرمة: هم أبو عامر الراهب والحرث بن سويد في اثني عشر رجلًا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية فيهم وأكثر الروايات على هذا والمراد من الآية استبعاد أن يهديهم أي يدلهم دلالة موصولة لا مطلق الدلالة قاله بعضهم، وقيل: إن المعنى كيف يسلك بهم سبيل المهديين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد فعلوا ما فعلوا، وقيل: إن الآية على طريق التبعيد كما يقال: كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي هداهم به وقد تركوه ولا طريق غيره، وقيل: إن المراد كيف يهديهم إلى الجنة ويثيبهم والحال ما ترى؟ {وَشَهِدُواْ أَنَّ الرسول} وهو محمد صلى الله عليه وسلم {حَقّ} لا شك في رسالته {وَجَاءهُمُ البينات} أي البراهين والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه، وقيل: القرآن، وقيل: ما في كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام، {وَشَهِدُواْ} عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل لأنه عنى آمنوا، والظاهر أنه عطف على المعنى كما في قوله تعالى: {إِنَّ المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُواْ الله} [الحديد: 18] لا على التوهم كما توهم؛ واختار بعضهم تأويل المعطوف ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بأن يقدر معه أن المصدرية أي: وإن شهدوا أي وشهادتهم على حد قوله: وإلى هذا ذهب الراغب وأبو البقاء، وجوز عطفه على {كَفَرُواْ} وفساد المعنى يدفعه أن العطف لا يقتضي الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه، واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه أو قبله؛ وأجيب بالمنع لأنه لا يلزم تقييد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لأخر، وقيل: يمنع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين الشهادة والكفر، وأجيب بالمنع بل هم جامعون وإن لم يكن ذلك معًا، ومن الناس من جعله معطوفًا على {كَفَرُواْ} ولم يتكلم شيئًا مما ذكر، وزعم أن ذلك في المنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول، والأكثرون من المحققين على اختيار الحالية من الضمير في {كَفَرُواْ} وقد معه مقدرة، ولا يجوز أن يكون العامل يهدي لأنه يهدي من شهد أن الرسول حق وعليه، وعلى تقدير العطف على الإيمان استدل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان، ووجه ذلك أن العطف يقتضي بظاهره «المغايرة» بين المعطوف والمعطوف عليه وأن الحالية تقتضي التقييد ولو كان الإقرار داخلًا في حقيقة الإيمان لخلا ذكره عن الفائدة، ولو كان عينه يلزم تقييد الشيء بنفسه ولا يخفى ما فيه، وادعى بعضهم أن المراد من الإيمان الإيمان بالله، ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسول صلى الله عليه وسلم، والأمر حينئذ واضح فتدبر {والله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين} أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر، ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه؛ ويجوز حمل الظلم مطلقه فيدخل فيه الكفر دخولًا أوليًا، والجملة اعتراضية أو حالية.
{أولئك} أي المذكورون المتصفون بأشنع الصفات وهو مبتدأ، وقوله سبحانه: {جَزَآؤُهُمْ} أي جزاء فعلهم مبتدأ ثان، وقوله عز شأنه: {أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله والملئكة والناس أَجْمَعِينَ} خبر المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر المبتدأ الأول قيل: وهذا يدل نطوقه على جواز لعنهم، ومفهومه ينفي جواز لعن غيرهم، ولعل الفرق بينهم وبين غيرهم حتى خص اللعن بهم أنهم مطبوع على قلوبهم ممنوعون بسبب خياثة ذواتهم وقبح استعدادهم من الهدى آيسون من رحمة الله تعالى بخلاف غيرهم، والخلاف في لعن أقوام بأعيانهم ممن ورد لعن أنواعهم كشارب خمر معين مثلا مشهور والنووي على جوازه استدلالا بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله تعالى من فعل هذا وا صح أن الملائكة تلعن من خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، وأجيب بأن اللعن هناك للجنس الداخل فيه الشخص أيضًا، واعترض بأنه خلاف الظاهر كتأويل إن وراكبها بذلك والاحتياط لا يخفى والمراد من الناس إما المؤمنون لأنهم هم الذين يلعنون الكفرة، أو المطلق لأن كل واحد يلعن من لم يتبع الحق، وإن لم يكن غير متبع بناءًا على زعمه.
{خالدين فِيهَا} حال من الضمير في {عَلَيْهِمْ} [آل عمران: 78] والعامل فيه الاستقرار، والضمير المجرور للعنة أو للعقوبة أو للنار، وإن لم يجر لها ذكر اكتفاءًا بدلالة اللعنة عليها {لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذاب وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} أي لا يمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر، أو لا ينظر إليهم ولا يعتد بهم، والجملة إما مستأنفة أو في محل نصب على الحال.
{إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك} أي الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيمان {وَأَصْلَحُواْ} أي دخلوا في الصلاح بناءًا على أن الفعل لازم من قبيل أصبحوا أي دخلوا في الصباح، ويجوز أن يكون متعديًا والمفعول محذوف أي أصلحوا ما أفسدوا ففيه إشارة كما قيل إلى أن مجرد الندم على ما مضى من الارتداد، والعزم على تركه في الاستقبال غير كاف لما أخلوا به من الحقوق، واعترض بأن مجرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر الحق إليهم، فالظاهر أنه ليس تقييدًا بل بيان لأن يصلح ما فسد. وأجيب بأنه ليس بوارد لأن مجرد الندم والعزم على ترك الكفر في المستقبل لا يخرجه منه فهو بيان للتوبة المعتد بها، فالمآل واحد عند التحقيق. {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي فيغفر كفرهم ويثيبهم، وقيل: {غَفُورٌ} لهم في الدنيا بالستر على قبائحهم {رَّحِيمٌ} بهم في الآخرة بالعفو عنهم ولا يخفى بعده والجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء.
{إِنَّ الذين كَفَرُواْ بَعْدَ إيمانهم ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا} قال عطاء وقتادة: نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم، ثم {ازدادوا كُفْرًا} حمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقيل: في أهل الكتاب آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ثم كفروا به بعد مبعثه، ثم ازدادوا كفرًا بالإصرار والعناد والصد عن السبيل، ونسب ذلك إلى الحسن، وقيل: في أصحاب الحرث بن سويد فإنه لما رجع قالوا: نقيم كة على الكفر ما بدا لنا فمتى أردنا الرجعة رجعنا فينزل فينا ما نزل في الحرث، وقيل: في قوم من أصحابه ممن كان يكفر ثم يراجع الإسلام، وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانئ. و{كُفْرًا} تمييز محول عن فاعل، والدال الأولى في {ازدادوا} بدل من تاء الافتعال لوقوعها بعد الزاي. {لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} قال الحسن وقتادة والجبائي: لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة وعند ذلك لا تقبل توبة الكافر، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنها لم تكن عن قلب، وإنما كانت نفاقًا، وقيل: إن هذا من قبيل: أي لا توبة لهم حتى تقبل لأنهم لم يوفقوا لها فهو من قبيل الكناية كما قال العلامة دون المجاز حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوم، وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما دل عليه الاستثناء وتقرر في الشرع كما لا يخفى، وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنها مع إصرارهم على الكفر فردت عليهم لذلك، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم فلم تقبل توبتهم ولو كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة، وتجيء على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع وقد بسط الكلام عليها في الأصول. {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضالون} عطف إما على خبر {ءانٍ} فمحلها الرفع، وإما على {ءانٍ} مع اسمها فلا محل لها، و{الضالون} المخطؤون طريق الحق والنجاة، وقيل: الهالكون المعذبون والحصر باعتبار أنهم كاملون في الضلال فلا ينافي وجود الضلال في غيرهم.
{إِن الذين كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ} أي على كفرهم. {فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مّلْء الأرض} من مشرقها إلى مغربها {ذَهَبًا} نصب على التمييز، وقرأ الأعمش ذهب بالرفع، وخرج على البدلية من {مّلْء} أو عطف البيان، أو الخبر لمحذوف، وقيل عليه: إنه لابد من تقدير وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولم يعهد بيان المعرفة بالنكرة، وجعله خبرًا إنما يحسن إذا جعلت الجملة صفة، أو حالًا ولا يخلو عن ضعف، وملء الشيء بالكسر مقدار ما يملؤه، وأمل مَلء بالفتح فهو مصدر ملأه ملأ، وأما الملاءة بالضم والمد فهي الملحفة. وههنا سؤال مشهور وهو أنه لم دخلت الفاء في خبر {ءانٍ} هنا ولم تدخل في الآية السابقة مع أن الآيتين سواء في صحة إدخال الفاء لتصور السببية ظاهرًا؟ وأجاب غير واحد بأن الصلة في الآية الأولى الكفر وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغي لقبلت بخلاف الموت على الكفرة في هذه الآية فإنه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال: من جاءني له درهم كان إقرارًا بخلاف ما لو قرنه بالفاء كما هو معروف بين الفقهاء ولا يرد أن ترتب الحكم على الوصف دليل على السببية لأنا لا نسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يكون لأغراض كالإيماء إلى تحقق الخبر كقوله: وقد فصل ذلك في المعاني؛ وقرئ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض على البناء للفاعل وهو الله تعالى ونصب ملء وملء الأرض بتخفيف الهمزتين. {وَلَوِ افتدى بِهِ} قال ابن المنير في الانتصاف: إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطًا آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك: أكرم زيدًا ولو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره أكرم زيدًا لو أحسن ولو أساء إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى؛ ومنه {كُونُواْ قَوَّامِينَ بالقسط شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} [النساء: 135] فإن معناه والله تعالى أعلم لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهًا على أن ما كان أسهل أولى بالوجوب، ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه: {وَلَوِ افتدى بِهِ} يقتضي شرطًا آخر محذوفًا يكون هذا المذكور منبهًا عليه بطريق الأولى، والحالة المذكورة أعني حالة افتدائهم لء الأرض ذهبًا هي أجدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها خاض المفسرون بتأويلها فذكر الزمخشري ثلاثة أوحه حاصل الأول: أن عدم قبول ملء الأرض كناية عن عدم قبول فدية مّا لدلالة السياق على أن القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويرًا للتكثير لأنه الغاية التي لا مطمح وراءها في العرف، وفي الضمير يراد {مّلْء الأرض} على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى لء الأرض ذهبًا ففي الأول نظر إلى العموم وسده مسد فدية ما، وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامها، وحاصل الثاني: أن المراد ولو افتدى ثله معه كما صرح به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية أيضًا كأنه قيل: لا يقبل ملء الأرض فدية ولو ضوعف، ويرجع هذا إلى جعل الباء عنى مع، وتقدير مثل بعده أي مع مثله، وحاصل الثالث: أنه يقدر وصف يعينه المساق من نحو كان متصدقًا به، وحينئذ لا يكون الشرط المذكور من قبل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل يكون شرطًا محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه ملء الأرض ذهبًا لو تصدق ولو افتدى به أيضًا لم يقبل منه وضمير {بِهِ} للمال من غير اعتبار وصف التصدق فالكلام من قبيل:{وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} [فاطر: 11]، وعندي درهم ونصفه انتهى، ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف، وقريب من ذلك ما قيل: إن الواو زائدة، ويؤيد ذلك أنه قرئ في الشواذ بدونها وكذا القول: بأن {لَوْ} ليست وصلية بل شرطية، والجواب ما بعد أو هو ساد مسده، وذكر ابن المنير في الجواب مدعيًا أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعى أنه من السهل الممتنع أن قبول الفدية التي هي ملء الأرض ذهبًا تكون على أحوال تارة تؤخذ قهرًا كأخد الدية، وكرة يقول المفتدي: أنا أفدي نفسي بكذا ولا يفعل، وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول، وهي أن يفتدي لء الأرض ذهبًا افتداءًا محققًا بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه اختيارًا، ومع ذلك لا يقبل منه فلأن لا يقبل منه مجرد قوله: أبذل المال وأقدر عليه، أو ما يجري هذا المجرى بطريق الأولى فتكون الواو والحالة هذه على بابها تنبيهًا على أن ثم أحوالًا أخر لا يقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذكورة، وقوله تعالى: {ولو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدوا به} مصرح بذلك، والمراد به أنه لا خلاص لهم من الوعيد وإلا فقد علم أنهم في ذلك اليوم أفلس من ابن المُذَلَّق لا يقدرون على شيء، ونظير هذا قولك: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إليَّ في يدي انتهى، وقريب منه ما ذكره أبو حيان قائلًا: إن الذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافرًا لا يقبل منه ما يملأ الأرض من ذهب على كل حال يقصدها ولو في حال افتدائه من العذاب لأن حالة الافتداء لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه إذ هي حالة قهر من المفتدى منه، وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن لو تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصًا على الحالة التي يظن أنه لا تندرج فيما قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» و«ردوا السائل ولو بظلف محرق» كأن هذه الأشياء مما لا ينبغي أن يؤتى بها لأن كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى، وكذلك الظلف المحرق لا غناء فيه فكان يناسب أن لا يرد السائل به. وكذلك حال الافتداء يناسب أن يقبل منه ملء الأرض ذهبًا لكنه لا يقبل، ونظيره {وَمَا أَنتَ ؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صادقين} [يوسف: 17] لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي أن يصدقوا فيها ولو لتعميم النفي والتأكيد له. هذا وقد أخرج الشيخان وابن جرير واللفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى: {إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مّلْء الأرض ذَهَبًا وَلَوِ افتدى بِهِ}. {أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} إسم الإشارة مبتدأ والظرف خبر ولاعتماده على المبتدأ رفع الفاعل، ويجوز أن يكون {لَهُمْ} خبرًا مقدمًا، و{عَذَابِ} مبتدأ مؤخرًا، والجملة خبر عن اسم الإشارة والأول أحسن، وفي تعقيب ما ذكر بهذه الجملة مبالغة في التحذير والإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء را يعفى عنه تكرمًا {وَمَا لَهُم مّن ناصرين} في رفع العذاب أو تخفيفه، و{مِنْ} مزيدة بعد النفي للاستغراق وتزاد بعده سواء دخلت على مفرد أو جمع خلافًا لمن زعم أن ذلك مخصوص بالمفرد، وصيغة الجمع لمراعاة الضمير، وفيها توافق الفواصل، والمراد ليس لواحد منهم ناصر واحد. وما باب الإشارة: {قُلْ ياأهل أَهْلِ الكتاب تَعَالَوْاْ إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] وهي كلمة التوحيد وترك اتباع الهوى والميل إلى السوى فإن ذلك لم يختلف فيه نبي ولا كتاب قط {مَا كَانَ إبراهيم} الخليل يهوديًا متعلقًا بالتشبيه {وَلاَ نَصْرَانِيّا} قائلًا بالتثليث {وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا} مائلا عن الكون برؤية المكون {مُسْلِمًا} [آل عمران: 67] منقادًا عند جريان قضائه وقدره، أو ذاهبًا إلى ما ذهب إليه المسلمون المصطفون القائلون {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السميع البصير} [الشورى: 11]، {إِنَّ أَوْلَى الناس بإبراهيم لَلَّذِينَ اتبعوه} بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوس عن الالتفات إلى العالمين فإن الخليل لما بلغ حضرة القدس زاغ بصره عن عرائس الملك والملكوت فقال: {إِنّي بَرِيء مّمَّا تُشْرِكُونَ إِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السموات والأرض} [الأنعام: 78، 79] {وهذا النبي} العظيم يعني محمدًا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسلم أولى أيضًا تابعة أبيه الخليل وسلوك منهجه الجليل لأنه زبدة مخيض محبته وخلاصة حقيقة فطرته {والذين ءامَنُواْ} به صلى الله عليه وسلم وأشرقت عليهم أنواره وأينعت في رياض قلوبهم أسراراه {والله وَلِىُّ المؤمنين} [آل عمران: 68] كافة يحفظهم عن آفات القهر ويدخلهم في قباب العصمة ويبيح لهم ديار الكرامة {وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ} جعله أهل الله سبحانه خطابًا للمؤمنين كما قال بذلك بعض أهل الظاهر أي لا تفشوا أسرار الحق إلا إلى أهله ولا تقرّوا عاني الحقيقة للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم ويقصدون سفك دمائكم {قُلْ إِنَّ الهدى} أعني {هُدَى الله أَن يؤتى أَحَدٌ مّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ} من علم الباطن، أو مثل ما يحاجوكم به في زعمهم عند ربكم وهو علم الظاهر. وحاصل المعنى: إن الهدى بين الظاهر والباطن وأما الاقتصار على علم الظاهر وإنكار الباطن فليس بهدى {قُلْ إِنَّ الفضل بِيَدِ الله} فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم في أزل الآزال {والله واسع عَلِيمٌ} [آل عمران: 73] فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسا تقتضيه الحكمة في المظاهر لأهل الشهود {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ} الخاصة {مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ} وهي المعرفة به وهي فوق مكاشفة غيب الملكوت ومشاهدة سر الجبروت، {والله ذُو الفضل العظيم} [آل عمران: 74] الذي لا يكتنه {بلى مَنْ أوفى بِعَهْدِهِ} وهو عهد الروح بنعت الكشف؛ وعهد القلب بتلقي الخطاب، وعهد العقل بامتثال الأوامر والنواهي {واتقى} من خطرات النفوس وطوارق الشهوات {فَإِنَّ الله يُحِبُّ المتقين} [آل عمران: 76] أي فهو بالغ مقام حقيقة المحبة {إِنَّ الذين يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيمانهم ثَمَنًا قَلِيًلا} [آل عمران: 77] الآية إشارة إلى من مال إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقربين ومزجها بحب الرياسة فذلك الذي سقط عن رؤية اللقاء ومخاطبة الحق في الدنيا والآخرة {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ الله الكتاب والحكم والنبوة ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لّى مِن دُونِ الله} لأن الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء في التوحيد فمن محا الله تعالى بشريته بإفنائه عن نفسه وأثابه وجودًا نورانيًا حقيًا قابلًا للكتاب والحكمة العقلية لا يمكن أن يدعو إلى نفسه إذ الداعي إليها لا يكون إلا محجوبًا بها، وبين الأمرين تناقض {ولكن} يقول: {كُونُواْ ربانيين} [آل عمران: 79] أي منسوبين إلى الرب، والمراد عابدين مرتاضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسراركم أنوار الرب، ولهم في الرباني عبارات كثيرة، فقال الشبلي: الرباني الذي لا يأخذ العلوم إلا من الرب ولا يرجع في شيء إلا إليه، وقال سهل: الرباني الذي لا يختار على ربه حالا، وقال القاسم: هو المتخلق بأخلاق الرب علمًا وحكمًا، وقيل: هو الذي محق في وجوده ومحق عن شهوده، وقيل: هو الذي لا تؤثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها وقيل وقيل. وكل الأقوال ترد من منهل واحد، {وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الملائكة والنبيين أَرْبَابًا} فإنها بعض مظاهره وهو سبحانه المطلق حتى عن قيد الإطلاق {أَيَأْمُرُكُم بالكفر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 80] أي أيأمركم بالاحتجاب برؤية الأشكال والنظر إلى الأمثال بعد أن لاح في أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد {وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين} [آل عمران: 18] الآية فيه إشارة إلى أنه سبحانه أخذ العهد من نواب الحقيقة المحمدية في الأزل بالانقياد والطاعة والإيمان بها، وخصهم بالذكر لكونهم أهل الصف الأول ورجال الحضرة، وقيل: إن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق التعارف بينهم وإقامة الدين وعدم التفرق وتصديق بعضهم بعضًا ودعوة الخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى وطاعة النبي وتعريف بعضهم بعضًا لأممهم، وهذا غير الميثاق العام المشار إليه بقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِى ءادَمَ} [الأعراف: 172] إلخ {فَمَنْ تولى بَعْدَ ذلك} أي بعد ما علم عهد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الأنبياء إليه ما عهد إليهم {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون} [آل عمران: 82] أي الخارجون عن دين الله تعالى ولا دين غيره معتدًا به في الحقيقة إلا توهمًا {أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السموات والأرض} أي من في عالم الأرواح وعالم النفوس، أو من في عالم الملكوت وعالم الملك {طَوْعًا} باختياره وشعوره {وَكَرْهًا} من حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بسبب احتجابه برؤية الأغيار، ولهذا سقط عن درجة القبول {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران: 83] في العاقبة حين يكشف عن ساق {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام} وهو التوحيد {دِينًا} له {فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} لعدم وصوله إلى الحق لمكان الحجاب {وَهُوَ فِي الاخرة} ويوم القيامة الكبرى {مّنَ الخاسرين} [آل عمران: 85] الذين خسروا أنفسهم {كَيْفَ يَهْدِى الله قَوْمًا} [آل عمران: 86] الآية استبعاد لهداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة، وحكم عليه بالكفر في سابق الأزل فإن من لم يكن له استعداد لم يقع في أنوار التجلي، ومن خاض في بحر القهر ولزم قعر بعد البعد لم يكن له سبيل إلى ساحل قرب القرب والله غالب على أمره ولله در من قال: هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
|